من قواعد البلاغة:
أنواع التشبيه
التشبيه هو أحد أساليب البيان التي يقصد بها إيضاح المعنى وتقريب الصورة لذهن المتلقي، وذلك لدوره في نقل الشعور ووصف الأحاسيس بأشكال وألوان متعددة، على نحو قول (فلان كالبحر في العطاء) هنا تم تشبيهه بالبحر لكثرة عطائه وجوده.
ويُعرف التشبيه بأنه عقد مقارنة تجمع بين طرفين لاتحادهما واشتراكهما في صفة أو حالة واحدة.
أما تعريفه كمصطلح بلاغي، فهو: إلحاق أمر (المشبه) بأمر (المشبه به) في معنى مشترك (وجه الشبه) باستخدام أداة (أداة التشبيه).
أركان التشبيه
وبعد التعريف السابق للتشبيه، فيمكن القول إن أركان التشبيه هي:
المشبه: هو الأمر المراد توضيحه وإبانة صورته.
المشبه به: وهو الأمر الذي يلحق به المشبه.
ويعد كلّاً من المشبه والمشبه به طرفا التشبيه، وهما ركناه الأساسيان.
أداة التشبيه: هي الرابط بين المشبه والمشبه به، على نحو قول: كاف التشبيه، كأن، مثل، مثيل، شبيه، يماثل.
وجه الشبه: وهو المعنى الذي اشترك به المشبه والمشبه به وجمع بينهما من أجله.
على نحو قول: علي كالجبل ثباتاً
وعليه فأركان التشبيه في البيت الشعري، هي:
المشبه: علي
المشبه به: الجبل
أداة التشبيه: الكاف
وجه الشبه: الثبات
أنواع التشبيه
ينقسم التشبيه إلى عدة أنواع باعتبار عوامل عدة، سيذكر أبرزها في الآتي:
أولاً: أنواع التشبيه باعتبار حضور الأداة أو غيابها
ينقسم التشبيه باعتبار ذكر أداة التشبيه أم لا إلى:
التشبيه المرسل: وهو ما ذكر فيه أداة التشبيه، على نحو: (أنت حاد البصر كالصقر)؛ في المثال ذُكرت أداة التشبيه (الكاف).
التشبيه المؤكد: وهو ما لم يذكر فيه أداة التشبيه، على نحو: (يغني غناء العصافير)؛ هنا لم تذكر أداة التشبيه، والتقدير هو يغني مثل غناء العصافير.
أنواع التشبيه باعتبار حضور وجه الشبه أو غيابه
ينقسم التشبيه باعتبار ذكر وجه الشبه أم لا إلى:
التشبيه المفصل: هو ما ذكر فيه وجه الشبه، على نحو: (خلق عليّ كالنسيم رقةً)؛ هنا ذكر وجه الشبه وهو الرقة التي تجتمع في خلق علي والنسيم.
التشبيه المجمل: وهو ما لم يذكر فيه وجه الشبه، على نحو: (النحو في الكلام كالملح في الطعام)؛ هنا لم يذكر وجه الشبه، ولكن المعنى أن النحو يُصلح الكلام، كما يُصلح ويحسن الملح الطعام.
.jpg)



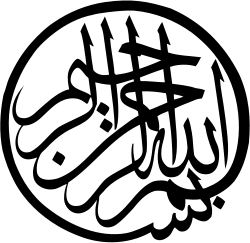


.jpg)
